لا تزال الصراعات العرقية في سبيل الحرية الجماعية (كتلك التي يخوضها الأكراد) قوية، لكن رصدت الشعوب العربية في معظمها، داخل بلدان مثل سوريا والعراق، حاجزاً جديداً أمام الحرية: الأنظمة الدكتاتورية وقادتها. قُمِعت تحركات المعارضة بدرجات مريعة، ما أدى إلى نشوء أشكال متنوعة من المقاومة التي تشتق من زوايا مختلفة: الديموقراطيون الليبراليون، الإسلاميون، الأقليات العرقية والدينية، الأغلبيات خارج السلطة... تأثّرت طريقة فهم هذا الوضع المستجد أيضاً باستيراد الليبرالية وتركيزها على الحقوق الفردية. مجدداً، سعى الناس إلى جلب نموذج ناجح في أوروبا إلى الشرق الأوسط، علماً أن الحكومات الأوروبية تعامل مواطنيها كأفراد بحد ذاتهم وتضمن حقوقهم بغض النظر عن هويتهم الدينية أو العرقية. زال أول حاجز أمام الحرية، أي العامل المرتبط بالهيمنة الخارجية، لكنه كشف في المقابل عن طبقات أخرى من الظلم. لكن يتمتع مبدأ الحقوق الفردية بجاذبية كبرى ولن تتخلى عنه شعوب المنطقة، حتى لو غرق الشرق الأوسط في فوضى إضافية. وعند النظر إلى الوضع من الخارج، يبدو أن الانقسامات العرقية والطائفية هي التي تحرك الأحداث، لا الصراعات في سبيل الديموقراطية الليبرالية.

في سوريا مثلاً، حيث نجح النضال في سبيل التحرر العربي الجماعي من الاستعمار التركي والأوروبي، انتقل المستاؤون من الحكم البعثي إلى النضال لاكتساب حريات مختلفة. بنظر البعض، كان النضال يتمحور حول الحرية الفردية، على غرار الحريات السياسية وحرية التعبير. وبالنسبة إلى البعض الآخر، كان النضال في سبيل الحرية الدينية أساسياً. عملياً، يعني هذا النوع الأخير من النضال استبدال العلمانية الاستبدادية المزيفة بنظام ديني استبدادي مبني على حكم الأغلبية. في العام 2011، اصطدم هذان النضالان بعدو مشترك: الدولة البعثية القمعية. لكن لم يحمل مؤيدو هذه الجهود رؤية مشتركة عن سوريا في حقبة ما بعد الحكم البعثي، وبقيت الخطوط بين هذين الفكرَين مبهمة طبعاً. هل كانت الحرية تعني الحقوق الفردية، لا سيما في المجال السياسي؟ أم أنها تشير إلى توسّع دور الطائفة السنية الطاغية في المجال العام؟ كانت طموحات نخبة المفكرين الليبراليين، في خضم تصدّيها للقمع البعثي، تختلف بشدة عن طموحات "الإخوان المسلمين".في تطور آخر، تابعت الجماعات العرقية غير العربية مساعيها لتحقيق الحرية الجماعية التي اكتسبها العرب سابقاً. في العراق، خاض الأكراد معركة طويلة ومتقطعة في سبيل الحقوق الجماعية ضد الدولة العراقية. حاول الأكراد والسريان في شمال شرق سوريا أن يضمنوا الاعتراف بحقوق شعوبهم باعتبارها جماعات غير عربية، فأسسوا عدداً من الأحزاب السياسية الجديدة. في العام 2003، نشأ "حزب الاتحاد الديموقراطي" لتمثيل الحقوق السياسية الكردية، مع أن الأحزاب السياسية الكردية كانت قائمة منذ وقت طويل. كذلك، تأسس "حزب الاتحاد السرياني" في العام 2005، في محاولة للاعتراف بالأقلية السريانية المسيحية كجماعة غير عربية.
بالنسبة إلى هذه الحركات، كان النضال من أجل الحرية يهدف في المقام الأول إلى الاعتراف بوجود شعوب غير عربية داخل الجمهورية العربية السورية. بدءاً من العام 2012، وصلت تلك الأحزاب إلى السلطة في شمال شرق سوريا، وشكّلت في نهاية المطاف إدارة مستقلة تحكم المناطق التي تخضع لسيطرة القوات الديموقراطية السورية، وهو تحالف يمثّل انتماءات عرقية متعددة. وفق أهم مبدأ في الإدارة المستقلة، يحق لكل جماعة عرقية أو دينية أن تعيش ضمن نظام حكم مشترك. يعتبر النقاد هذا التوجه مشروعاً قومياً كردياً يختبئ وراء مفهوم التعددية ويهدف بكل بساطة إلى استبدال "عربستان" بكردستان. في المقابل، يقول المدافعون عن هذا المشروع إنه النظام الوحيد الذي يضمن المساواة بين الجماعات الكردية والسريانية والعربية (فضلاً عن أقليات أصغر حجماً مثل الأرمن والتركمان والشركس). حتى أنه يعترف بأن السوريين يعتبرون أنفسهم قبل كل شيء جزءاً من جماعة واحدة ثم أفراداً مستقلين، من الناحية السياسية على الأقل. ولا يمكن احترام الحقوق الفردية ما لم تترسخ حقوق مختلف الجـماعات داخل سوريا.أصبح هذا المشروع محصّناً بفضل الوجود العسكري الغربي في شمال شرق سوريا، لكنه يواجه اليوم تهديداً وجودياً بسبب تركيا والنظام السوري في آن. بعد قرار الرئيس ترامب سحب القوات الأميركية من سوريا (عاد وغيّر رأيه لاحقاً)، غزت تركيا المنطقة (أو يمكن القول إن التهديدات التركية بالغزو كانت الدافع وراء الانسحاب الأميركي). تعترض تركيا على نشوء الإدارة المستقلة بشكلٍ أساسي لأنها تخشى أن يؤدي هذا النموذج إلى تقوية المجتمع الكردي، علماً أن الحكومة التركية تتابع حتى الآن حرمان الأكراد من حقوقهم الجماعية. كذلك، لا تتعاطف الأغلبيات التركية في تركيا والعربية في سوريا مع الطموحات الكردية وتطالب بإخضاع هذه الأقلية للمشروع القومي الشامل. لا عجب إذاً في أن يسارع "الحزب الديموقراطي الشعبي"، وهو الحزب السياسي الكردي في معظمه داخل تركيا، إلى استنكار محاولة الانقلاب العسكري في تموز 2016 في تركيا، رغم معارضته الشديدة لحكومة "حزب العدالة والتنمية" بقيادة أردوغان. لو نجح ذلك الانقلاب، كان الوضع ليقتصر على استبدال حكم قومي تركي ظالم بنسخة أخرى منه. في الوقت نفسه، تباطأت الجماعة الكردية في شمال شرق سوريا في الدعوة إلى إسقاط النظام في العام 2011، لأن الانتقال من النظام البعثي إلى المعارضة كان ليوازي مقايضة كيان قومي عربي بآخر، نظراً إلى ترسّخ مفهوم العروبة في الروح الوطنية السورية وفي النظام والمعارضة على حد سواء.أمام هذا الوضع، يواجه كل من يدعو إلى "الحرية" ويسعى إلى اكتسابها في الشرق الأوسط معضلة حقيقية لأن زوال طبقات "انعدام الحرية" يعني نشوء أنواع جديدة من العوائق. أحياناً، تبقى تلك الطبقات قائمة ولا تُكشَف تناقضاتها مطلقاً. في ما يخص الفلسطينيين مثلاً، يبقى النضال في سبيل الحرية جماعياً، وتبقى إسرائيل والصهيونية حاجزاً أمام تلك الحرية. لكن إذا زالت تلك الحواجز، من خلال إقامة دولة فلسطينية مستقلة مثلاً، هل سيتحرر الشعب الفلسطيني في هذه الحالة؟ لا يمكن إعطاء جواب جازم. قد يجدون أنفسهم حينها في وضعٍ مشابه لجيرانهم العرب الذين تحرروا من القوى الاستعمارية منذ وقت طويل لكن لا يمكن اعتبارهم أحراراً رغم ذلك. ونظراً إلى حجم الاضطرابات السائدة في العقد الأخير، لم يعتبر الشعب يوماً وضع المراوحة مرادفاً للحرية، بغض النظر عن تعريفها.يحمل كل بلد في العالم العربي تاريخاً مختلفاً وبنية سياسية فريدة من نوعها، لذا يصعب تعميم الاستنتاجات على المنطقة كلها. مع ذلك، لم تواجه جميع البلدان العربية المبنية على نظام ملكي، من دون أي استثناء تقريباً، تهديدات خطيرة على سلطة الدولة منذ بداية الربيع العربي. نذكر منها: المغرب، الأردن، المملكة العربية السعودية، سلطنة عمان، قطر، الكويت. أما البحرين، فتبقى مثالاً شائكاً لكن يمكن إدراجها على هذه اللائحة حتى الآن.
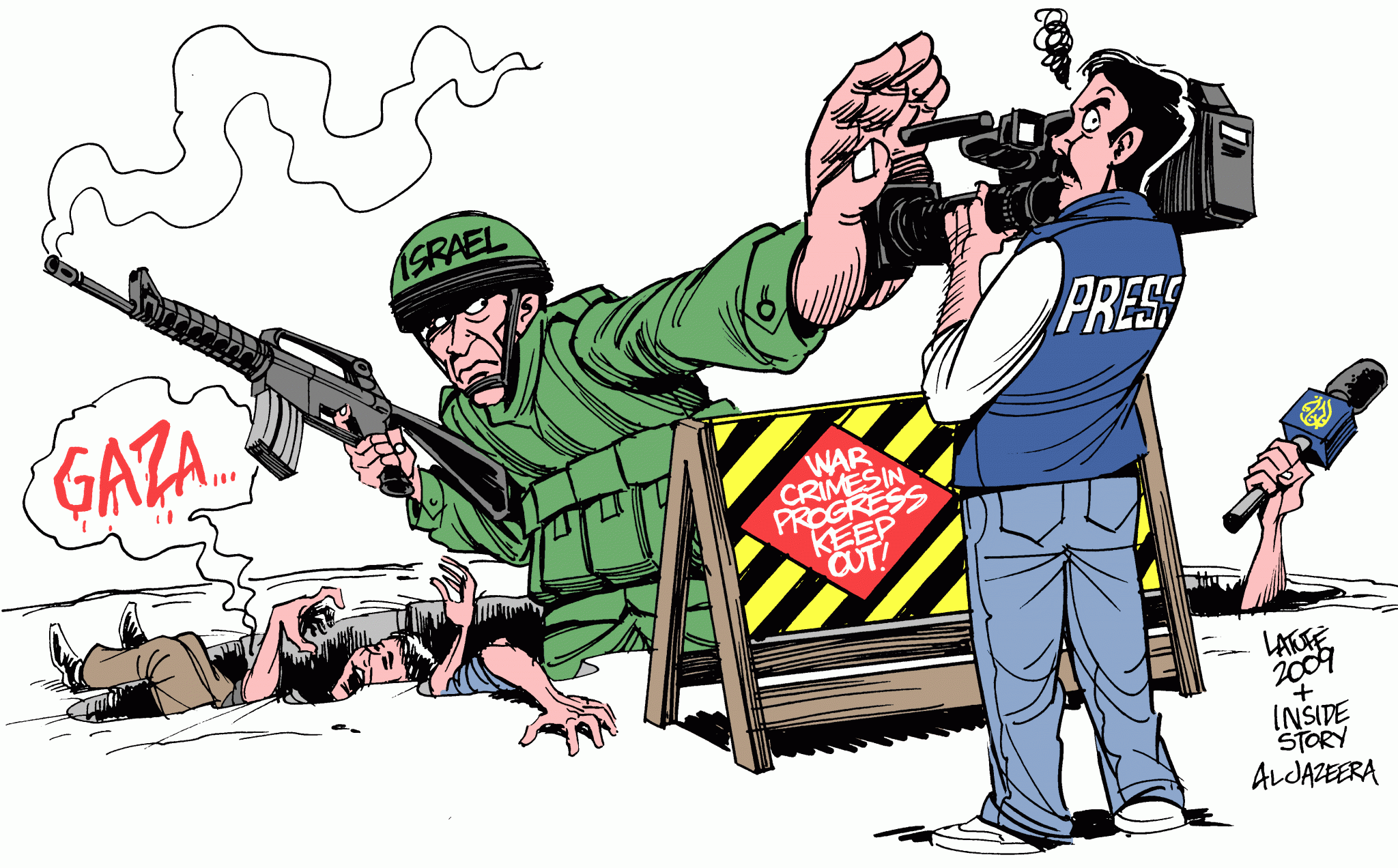
في المقابل، شهدت جمهوريات المنطقة كلها انهياراً حكومياً أو تهديدات خطيرة ترتبط بسيطرة الدولة على السلطة (الجزائر، تونس، مصر، السودان، سوريا، اليمن، ليبيا، العراق). في هذا الإطار أيضاً، يُعتبر لبنان مثالاً شائكاً، لكن تثبت الاحتجاجات المستمرة ضد الحكومة هناك أن النظام اللبناني يبقى هشاً. مع ذلك، يمكن إدراجه على هذه اللائحة رغم تركيبته السكانية الفريدة من نوعها وتاريخه الاستثنائي الذي يميّزه عن جميع بلدان المنطقة.هذا التناقض بين الأنظمة الملكية والجمهوريات (باستثناء بعض النماذج الشائبة) يطرح تساؤلاً عن مدى ارتباط الشرعية والسلطة بالحرية: هل يمكن إنشاء نظام شرعي يضمن حقوق الأفراد ومختلف الجماعات في آن داخل هذه البلدان المتنوعة؟ اكتسبت الأنظمة الملكية الشرعية، لكنها ليست حرّة في معظمها. وتتّسم جمهوريات معينة بهامش من "الحرية" التي تصل إلى حد الفوضى السياسية، كما في العراق ولبنان. لذا يتعيّن على العالم العربي اليوم أن يجد النظام المناسب، أي النوع الذي يضمن له الحرية والشرعية معاً. إنه هدف أساسي للبلدان غير العربية في المنطقة أيضاً.
لا يزال النظام السياسي الشرعي الذي يضمن الحرية بعيد المنال في الشرق الأوسط. يجب أن يُركّز المفكرون الجديون في المنطقة برسم معالم هذا النظام وتحديد طريقة تطبيقه. هل يستطيع المحتجون في بيروت وبغداد تقديم حل فاعل للمشكلة؟ لا يفكر هؤلاء بهذا الموضوع على الأرجح لأنهم منشغلون بتجنب الرصاص من حكوماتهم المُنتخَبة. لكنّ النجاح أو الفشل في إنشاء نظام سياسي شرعي وحر سيُحدد مستقبل المنطقة أكثر من أي عامل آخر، فيما يدخل الشرق الأوسط في العقد الثالث من القرن الواحد والعشرين بخطوات متعثرة ودموية.


