حسناً فعل «المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات» أن أصدر معاً كتابَي «ما الغرب؟» لفيليب نيمو و»ماذا تبقّى من الغرب؟» لريجيس دوبريه ورينو جيرار (ترجمة مراد دياني). ففي جمعه ثلاثة آراء لم يترك صوتاً واحداً يتحدّث عن «الغرب»، ووفّر فرصة للقارئ العربي كي يطّلع على «أطروحات» ثلاثة مفكرين. فهؤلاء، وفي حين ينطلقون من موقع الإنتماء إلى «الغرب»، يحدّد كل منهم مسافة بينه وبين «موضوع» البحث. فنيمو القلق على «الغرب» يقدم سردية ليبرالية داعياً إلى الوحدة؛ ودوبريه يُخضع «الغرب» لما يسمّيه «فحصاً سريرياً» راسماً مشهداً رمادياً؛ وإذ يتّفق جيرار معه في شأن «ضبابية» الوضع، يبدو أقل نقدية مركِّزاً على السياسة الخارجية التي يراها مشكلة ويدعو إلى تغييرها.
ينطلق الفيلسوف الفرنسي الليبرالي فيليب نيمو في كتابه «ما الغرب؟» من رسالتي فيخته «إلى الأمة الألمانية» (1808)، وجوليان بندا «إلى الأمة الأوروبية» (1933). ويرى أن «الظروف الجيوسياسية اليوم تدعو إلى توجيه رسالة إلى الأمة الغربية». واللافت هو أن القلق الألماني عند فيخته والأوروبي عند بندا، يغدو عند نيمو قلقاً على «الأمة الغربية». فنيمو يجعل «الغرب» أمة. وهذا، الذي يستخدم في سبيل صوغه قراءة «خاصّة» للتاريخ الأوروبي، ليس «المفاجئ» الوحيد في الكتاب. بل إن «الصادم» هو إفراط نيمو في الليبرالية التطوريّة التي يستند فيها إلى فردريك هايك. فهذه النظرة التي يسميها نيمو «علمية باردة، لا تكترث للمتضررين من «التقدم»، سواء أكان في الغرب أم في البلدان التي استعمرها. وعلى الرغم من القلق يرسم مؤلّف كتاب «تاريخ الأفكار السياسية» صورة وردية للغرب. الذي يؤثر ولا ولم يتأثر. وهذا أمر غير دقيق تاريخيا وثقافيا.
خمسة أحداث
يعرّف نيمو الحضارة الغربية عبر «دولة القانون، والديمقراطية، والحريات الفكرية، والعقلانية النقدية، والعلم، واقتصاد حر قائم على الملكية الخاصّة». وفيما يعتبر أن هذه «القيم والمؤسّسات هي ثمرة بناء تاريخي طويل»، يعتقد أنه في الإمكان «هيكلة التشكيل الحيوي الثقافي للغرب عبر خمسة أحداث رئيسية:
1. إبتداع الإغريق المدينة، والحرية في ظل القانون، والعلم، والمدرسة.
2. إبتداع روما القانون، والملكية الخاصّة، والشخص، والمذهب الإنساني.
3. ثورة الكتاب المقدس الأخلاقية والأخروية، حين تجاوز الإحسان العدالة، وجرى التشغيل الأخروي لزمن خطي، زمن التاريخ.
4. الثورة البابوية بين القرنين الحادي عشر والثالث عشر، التي اختارت استخدام العقل البشري في صورَتي العلوم الإغريقية والقانون الروماني من أجل إدراج الأخلاقية والأخروية الإنجيليّتين في التاريخ محققة بذلك أول توليفة حقيقية بين أثينا وروما والقدس.
5. تعزيز الديمقراطية الليبرالية الذي أنجزه ما اتُّفق على تسميته الثورات الديمقراطية الكبرى (هولندا وإنكلترا والولايات المتحدة الأميركية وفرنسا، ثم بعد ذلك، بشكل أو بآخر، جميع البلدان الأخرى في أوروبا الغربية). وبما أن التعددية هي أكثر نجاعة من أي نظام طبيعي أو أي نظام اصطناعي في مجالات العلم والسياسة والاقتصاد، فقد منح هذا الحدث الأخير للغرب قوّة تطوّرٍ غير مسبوقة سمحت بتوليد الحداثة».
ولا يصوغ نيمو من خلال هذه الأحداث الخمسة مسار «الغرب» وثقافته فحسب، بل يرسم الحدود الفاصلة مع «الآخر» أو الآخرين. يكتب: «حدّدت الثورة البابوية قطيعة عميقة ودائمة بين المسيحية الغربية والأرثوذكسية... وعقب هذه الثورة، ولأن الشرق لم يحقق الطفرة الروحية نفسها، فسوف تتعمّق فجوة حقيقية بين هاتين المسيحيتين منذ القرن الحادي عشر حتى الزمن الحاضر».
وبناءً على هذه السردية التاريخية «التقدمية» لـ»الغرب»، يرى أن «الأنظمة الفاشية والشيوعية كانت مآزق تاريخية وخيانات للتقاليد الخاصة» بالغرب. ويضيف: «كانت ظواهر مَرضيّة... وارتداداً إلى أشكال اجتماعية سابقة عن الأحداث الروحية التي جرى عبرها بناء الغرب».
وفيما يعترف بأن ثمة «حضارات أخرى قبلت في بعض الأحيان عملياً التعددية الدينية»، يشدّد على أن الغرب وحده هو ما «جعل التعددية الفكرية قيمة إيجابية». ويرى أن الغرب وفّر «التربة الثقافية» التي ولدت فيها الديمقراطية: «حيث كان يوجد الاعتقاد والعقيدة بلامعصومية الإنسانية، وبحق الإنسانية في التطلع إلى مستقبل أفضل، وبعدم شرعية السلطة السياسية في أن تتولى بنفسها هذا المستقبل وأن تشكّل الأفق الأخير للحياة البشرية». يضيف: «إن نزع القدسية عن السلطة في أوروبا كان ثمرة اليهودية - المسيحية؛ وإن مفهوم العَلمانية مستقى من الكتاب المقدس... وتُثبت كلمات يسوع ’أعطوا ما لقيصر لقيصر...‘ توزيع الأدوار هذا».
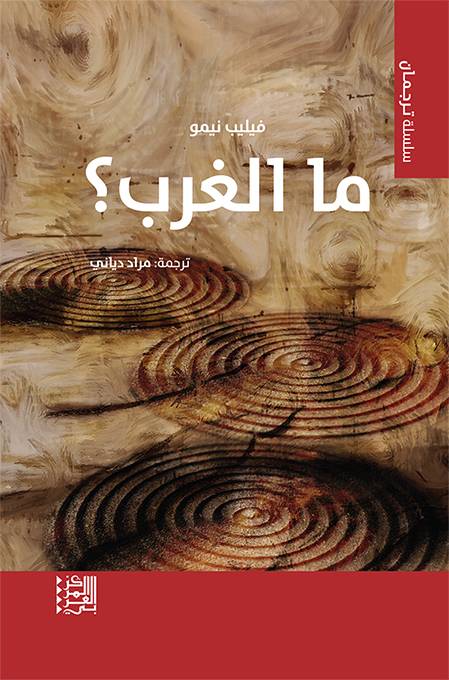
الثورة الصناعية والعصرنة
وإذ يرى أن «التفكير في الآليات الأساسية لاقتصاد السوق بدأ في الغرب منذ الثورة البابوية»، يحسم أن «اقتصاد السوق أخلاقي». ويأخذ على فرنسيس فوكوياما، الذي أصدر كتاب «نهاية التاريخ» بالتزامن مع انهيار الاتحاد السوفياتي ونموذجه الاشتراكي، أنه «اقترف خطيئة تفاؤل» عندما اعتبر أن «جميع بلدان العالم سوف تتبنى نموذج الديمقراطية الليبرالية». لكن، في الوقت نفسه، يجزم نيمو أنه «لا يوجد، حتى إشعار آخر، بديل جدي من هذا النموذج».
ويجد نيمو أن تعبير «الثورة الصناعية» «خطأ شائع» و»مضلل». وذلك «لأنه يوحي بأن السبب الناجع للتنمية الاقتصادية كان الصناعة أو التكنولوجيا بحد ذاتهما، في حين أن تنمية اقتصاد التبادلات هي ما جعلت الابتكار التقني ونمو الصناعة ممكنين. فما كَسَر الحلقة المفرغة لعدم التنمية، ليس هذا الاختراع العلمي أو التقني أو ذاك... إن ظهور الظروف الأخلاقية والاجتماعية - السياسية الجديدة المرخِّصة لروح المقاولة، وحرية المبادرات، وإمكانية لقاء العديد من العروض والطلبات في أسواق كبرى دائماً، هو ما سمح بإيقاظ هذه الإمكانات ومضاعفتها».
وينظر نيمو في «الوجه الكوني للثقافة الغربية». وإذ يذكّر بأن الانفجار الديموغرافي «الذي يمس اليوم العالم بأسره، قد بدأ في أوروبا»، ينفي عن الرأسمالية «إفقار الناس». ويصف هذه «التهمة» التي أطلقها المثقفون من اليسار واليمين بأنها «وهمٌ بصريٌّ مأسويٌّ». ويقول: «لم تُفقِر الرأسمالية الناس، وإنما- في مرحلة أولى- ضاعفت من الفقراء. بيد أنه من أجل مضاعفة الفقراء، ينبغي أن نكون أكثر ثراءً، وهذا ما كان عليه الاقتصاد الرأسمالي».
ويرى نيمو أن «ابتداع الغرب للقانون والسوق يمارس اليوم ضغط انتقاء على التطور الثقافي للجنس البشري بأسره». وعلى الرغم من أنه يرجح «ألا يستطيع أي مجتمع بشري الاستغناء عن ممارسته، إلا إذا قَبِل وضعية من الدونية البنيوية الدائمة مقارنة بالمجتمعات التي اعتمدته»، يستبعد- ببساطة- أن يُفضي ذلك إلى «مركزية إثنية» للغرب أو إلى «ثقافة تفوّق». وفيما يجزم أن «الإنسانية تتجه نحو تاريخ واحد»، يمدح الاستعمار: «كان الغرب مستعمِراً لأنه كان متفوّقاً تكنولوجياً واقتصادياً، وقد اكتسب هذا التفوق بفضل عملية التشكل الحيوي الثقافي... لم يكن في الاستعمار أي شر».
ويصل إلى سؤال: «هل تقتضي العصرنة التغريب؟»، وإذ يستعين بجواب الكاتب الإنكليزي من أصل هندي، ديباك لال، النافي لاقترانها، يميل إلى رأي رونالد إنغليهارت: «أينما وُجدت العصرنة، لاحظنا تغريباً سريعاً للعقليات والأعراف».
الحدود والآخر
أما حدود الغرب فهي «المجتمعات التي شهدت جميع الأحداث الخمسة». وفي حين أن «المجتمعات التي لم تشهد سوى عدد من هذه الأحداث تُعد قريبة من الغرب»، فإن «تلك التي لم تشهد أيّاً منها هي غريبة عنه». وإذ يُخرج «الدول الأرثوذكسية، روسيا والبلقان»، من الغرب على الرغم من أنها «إغريقية ورومانية ومسيحية» لكنها «لم تشهد الثورة البابوية»، يعدُّ «حالة إسرائيل خاصة». ويطرح في وجه نسبها إلى الغرب الأسئلة الآتية: «هل سوف يدمج اليهود بين اليهودية والصهيونية؟ هل سوف يعرفون كيف يتفادون أن تتحول الصهيونية إلى قومية عادية؟ هل سوف يعملون على أن تظل دولة إسرائيل، في المستقبل، دولة القانون على النمط الغربي، أو أنهم سوف يتركون البلاد تنتقل نحو نوع جديد من الثيوقراطية؟ وهل ستكون بالنسبة إليهم الديانة اليهودية و»الانتخاب» عنصر هوية يغلب الهوية الغربية بدلاً من التعايش معها؟».
وعلى الرغم من أن الإسلام عرف بعض «الأشكال السياسية للعَلمانية والديمقراطية» في العقود الأخيرة «بسبب هيمنة الغرب»، يقطع نيمو بأن هناك «مسافة حقيقية بين الثقافة الإسلامية والثقافة الغربية تُجبر على وضع الدول العربية - الإسلامية خارج نطاق الغرب (ومن ثم، فإن الهجرة الجماعية للجاليات المسلمة غير المتكيّفة في البلدان الغربية، لا تخلو من طرح مشكلة بليغة)».
وفي حين يؤكد أن «لا شيء مطلقاً أو جامداً في الخريطة» التي رسمها، و»العالم المعاصر هو مسرح تغيرات ثقافية سريعة»، يشدد على أنه «ليس من شأن هذه الجماعة الأهلية (الغرب) أن يكون لديها موقف عدائي مُسبق تجاه الحضارات الأخرى وبلدان العالم. بل من شأنها أن تحافظ على جميع العلاقات الثقافية والاقتصادية وحتى الاستراتيجية».
ويصف «الاتحاد الأوروبي والإمبراطورية الأميركية» بأنهما «فكرتان جيدتان وزائفتان». ولكونهما كذلك يدعو إلى وحدتهما على قاعدة أن «التعددية وتعدد الأقطاب ضروريان»... ويبقى أمام «الغرب» مهمة «تمديد الحدود» بوصفها «مسألة تربية».

رسائل ورؤى متباعدة
كتاب «ماذا تبقّى من الغرب؟» أقل قطعية في إجاباته من سردية نيمو. هو استفهامي ونقدي، وأقرب إلى السياسة والواقع الراهن، للغرب والعالم. وقد جُمعت مادته من تبادل رسائل بين مثقفَين فرنسيَّين بخلفيات متباينة: الفيلسوف ريجيس دوبريه، ورينو جيرار الكاتب الصحافي المتخصص في تغطية الحروب وقضايا الشرق الأوسط، والأستاذ في العلوم السياسية. وتتضمن الرسائل رؤى متباعدة إلى درجة التباين نحو المشكلات الرئيسية للغرب الحالي، وتذكّر بأفكار كتاب أوزوالد شبنغلر الشهير «انحدار الغرب» (1922).
اسم مستعار لـ»الناتو»
يطرق دوبريه إشكالية «نهاية الغرب» بسلوك منهجٍ أكاديميّ جدلي، مستبعداً تماسك الغرب تحت كنف الولايات المتحدة الأميركية وحدها. وفيما يشير إلى أن الريادة الأميركية مقبولة من كل الأطراف الغربية، يعتبر أن كلمة «الغرب» ليست سوى اسم مستعار لـ»الناتو». ويلاحظ أن التماسك «الغربي» الذي يشكل عنصر قوة في عالم غير مستقر جعل الغرب مجموعة أحادية القطب. ويلفت إلى أن هذا الأمر لم يتحقق في أي منطقة من العالم، لا في آسيا بين الصين والهند، ولا في أميركا الجنوبية بين البرازيل والأرجنتين، ولا في أفريقيا بين نيجيريا وجنوب أفريقيا، ولا حتى في «جامعة الدول العربية» و»رابطة دول جنوب شرق آسيا».
ويعتقد دوبريه أن التماسك والصوت الواحد زيَّنا للغرب فكرةَ «احتكار ما هو كوني»، فقدَّم نفسه مركزاً للعالم، وأن مصالحه هي مصالح الإنسانية بأسرها. ويصف ذلك بأنه المركزية الإثنية الغربية في أبشع صورها.
وبعدما يلفت إلى أن الصين «هي القوة التجارية الأولى في العالم، وعلى الأرجح، القوة الاقتصادية الأولى في عام 2030، ينظر إلى «حقائق الغرب بمنظور الطبيب المعالج الخبير، بدلاً من منظور مجبِّر العظام أو الحانوتي»، كما يقول.
ويبدأ بجرد قائمة عوامل النجاح، وهي إضافة إلى التماسك واحتكار ما هو كوني، أن «الغرب يؤمّن تكوين النخب الدولية في جامعاته وكلّياته للأعمال ومؤسساته المالية (صندوق النقد الدولي أو البنك الدولي)، ومدارسه العسكرية، ومنظماته التجارية، ومؤسساته الخيرية، وشركاته الكبرى». وإظهار الدولار كأنه العملة الاحتياطية للكون منذ عام 1945. وأخيراً، الابتكار العلمي والتقني.
ثم ينتقل إلى «نقاط الضعف»، وهي «الغطرسة العالمية المفرطة»، «عقدة التفوّق»، «إنكار التضحية» (بعبارة أخرى: إذا كان لدى الشرق حس المقدس، فإن الغرب وأوروبا على وجه الخصوص، قد تخلص منه. ومن هنا سوء فهم الغرب العميق أو ذعره المذهول أمام غريبي الأطوار الذين يفضّلون... النعيم في الآخرة على السعادة على هذه الأرض)، «سجن الزمن القصير» (نظرة مُشبعة بالمشهد السريع وبمقطع الفيديو القصير، وتُعد هذه النزعة الآنية لاواقعية واستراتيجية من حيث أنها تطمس الماضي والمستقبل)، و»تناثر العامل المخل بالنظام» (تدمير الدول الوطنية أو استنزافها تحت وطأة التدخل الخارجي، وتقدم جبهة الجهاد العالمي).
وخلاصة قول دوبريه: «هل يمكن أن يُقال عن الموازنة بين الأمجاد الخمسة والعبوديات الخمس، ليس لما يملكه الغرب وإنما لكينونته ذاتها التي هي في الآن ذاته أقوى وأضعف مما يعتقده، أنها متوازنة؟ على المستوى الدينامي، من المرجّح أنها ليست كذلك. وفي الأمد القصير، يبدو أنها كذلك. ليس لكون القائد المزعوم للحداثة هو على المسار الصحيح، بل هو بعيد من ذلك. فالخير الذي يعتقد أنه يُجسّده هو صورة خداعة ما عادت تخدع الناظر إليها إلا على نحو متناقص».
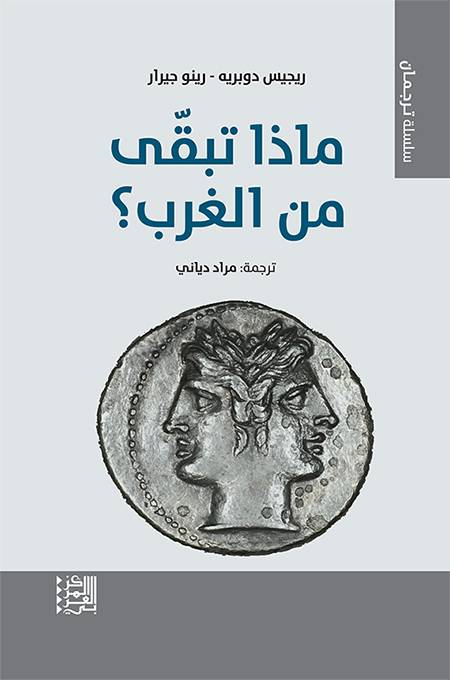
بوتين والأسد و «الفاشية الخضراء»
ويرد جيرار على هذه الصورة الرمادية للغرب، رافعاً ميزة قيام بلدان الغرب على سيادة القانون، بينما يعاني العالم دكتاتوريات ذات صور وأشكال عدة. ويشدّد على البُعدِ المسيحي بوصفه أهم السمات المميِّزة للغرب، ساعياً إلى تأكيد عدم تنافر الغرب مع روسيا وأوراسيا، خلافاً لمناطق أخرى لا تشترك معه في المرجعية المسيحية. ودليلاً على ذلك، يذكّر بابتعاد الغربيين في الثلاثينات من القرن العشرين عن الاتحاد السوفياتي بقيادة جوزيف ستالين، الذي لم يكن عدواً يسعى إلى خرابهم كما كانت ألمانيا النازية، وهو ما دفع الغرب ثمنه لاحقاً.
وكما في الماضي كذلك اليوم، يتعامل الغرب مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بوصفه عدوّاً له، في حين هو «غريم فحسب في لعبة النفوذ في أوكرانيا». ويُرجِع الفشل الغربي في التعامل مع بوتين إلى نفوذ المحافظين الجدد ومؤسسات الفكر والرأي الأميركية، التي لم تستطع التمييز بين الأطراف الغربية ذات طابع الاستبداد الشرقي لكنْ غير المعادية جوهريّاً للغرب وبين الأيديولوجيا الهدّامة لـ»الفاشية الخضراء» التي لم يفهم الغربيون طبيعتها حين غذَّوها، سواء في أراضيها الإسلامية، أم في أراضي الغرب.
وما ينطبق على ستالين وبوتين، بالنسبة إلى جيرار، ينسحب على بشار الأسد. فالرئيس السوري، وإن كان مكروهاً في بلده مثل ستالين، إلا أنه لا يحلم بدمار الغرب. ويعتبر أنه مثلما كانت النازية عدو الغرب، فإن «الفاشية الخضراء» هي عدو اليوم. وهذا ما لا تعيه النخبة السياسية في الغرب، التي تحكمها النظرة المانوية للعالم باعتباره مسرحاً لصراع الخير والشر. وإذ يجد جيرار أن الغرب «عاجز» عن تحديد العدو يدعو إلى الواقعية في السياسة الخارجية لدول الغرب.


